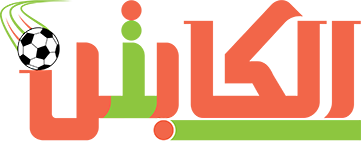عبدالإله بلقزيز يرصد طغيان الأيديولوجيا على المعرفة لدى العرب

منذ أيام، وقع اختيار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» على المفكر والأديب المغربى عبدالإله بلقزيز ليكون رمزًا للثقافة العربية لعام ٢٠٢٤، وهو اللقب الذى مُنح فى سنوات سابقة لكل من الشاعر الراحل محمود درويش، والفنانة الكبيرة فيروز.
ويُعد هذا التكريم مستحقًا لكاتب أثرى ساحة الثقافة العربية بمؤلفات مهمة تبحث فى أسئلة الفكر العربى وإشكالياته، من أبرزها: «من النهضة إلى الحداثة»، و«العرب والحداثة»، و«الدولة فى الفكر الإسلامى المعاصر»، و«محمد عابد الجابرى ونقد العقل العربى»، فضلًا عن الكتاب الصادر منذ شهور عن دار «الساقى»، بعنوان «الثقافة، المعرفة والأيديولوجيا»، ونلقى الضوء عليه هنا.
ضبط المفاهيم الملتبسة
يسعى عبدالإله بلقزيز فى كتابه «الثقافة، المعرفة والأيديولوجيا» إلى ضبط المفاهيم الملتبسة على صعيد الممارسة والتفكير، وتقديم التأصيل الفلسفى الدقيق لها، انطلاقًا من أن معظم فلاسفة اليوم وعلماء الاجتماع لم يقدموا، فى رأيه، شيئًا ذا بال فى سبيل التنمية النظرية.
وينظر «بلقزيز» فى أوجه تعاطى بعض الباحثين، وهم عبدالله العروى وناصيف نصار ومحمد سبيلا، مع مفهوم «الأيديولوجيا» فى كتاباتهم، وكذلك فى تحققه لدى بعض المفكرين العرب فى بعض أعمالهم، منهم أحمد أمين وألبرت حورانى وفهمى جدعان.
من المفاهيم الأساسية التى يقف المفكر المغربى محاولًا ضبطها: «الثقافة»، و«المعرفة»، و«الأيديولوجيا»، وهى مفاهيم ثلاثة جرى الخلط بينها بسبب إشكاليات فكرية يوضحها الكتاب فى الفصول التالية من الكتاب.
ويوضح «بلقزيز» أن الثقافة هى كل أثر مكتوب أو منقوش أو مرسوم أو حركى أو مرئى، وهى أوسع دلالة من المعرفة، لأن المعرفة تبقى جزءًا من الثقافة، وتتعلق بآليات التفكير ومنتوجه، وتؤسس على مبدأ الموضوعية، أما الأيديولوجيا فتُبنى على المصلحة.
تختلف المعرفة عن الثقافة فى كونها ليست تعبيرًا عن الذات، وإنما عن رؤية وتصور إلى العالم والأشياء. ومع ذلك، فإن موضوعية المعرفة تظل مسألة إشكالية، لأنه ليس من اليسير نفى البعد الذاتى والأيديولوجى، خاصة فى العلوم الإنسانية.
كما أن المفهوم التبسيطى للأيديولوجيا يتجاهل حقيقة كونه إشكاليًا، بسبب تعدد معانيه وتعدد استخداماته، وإمكانية تعبير الأيديولوجى عن نفسه بلغة وأدوات معرفية، فيصير ثمة تداخل بين البُعدين المعرفى والأيديولوجى فى عدد من الصور، مثل الطريقة التى يُقدّم بها موضوعًا، أو الأسئلة التى تُطرح عن موضوع معرفى ما.
ويرى «بلقزيز» أن الأيديولوجيا تستحق الدرس العلمى الرصين لا القدح والذم. فمن منظور المعرفة يمكن اعتبارها نمطًا زائفًا من الإدراك يهدف إلى طمس الحقائق. ومن منظور سوسيولوجى هى رؤية تكونها الجماعات الاجتماعية عن نفسها وعن العالم من حولها، فتكون تجسيدًا للوعى الذاتى وتعبيرًا عن مصالحها المادية، أما من منظور ثقافى فيمكن أن تطابق الأيديولوجيا مفهوم الثقافة الجمعية.
الإنتاج الفكرى العربى
يعاين المفكر المغربى أوجه التداخل بين المعرفى والأيديولوجى فى الإنتاج الفكرى العربى، ويصل إلى ملاحظة الحضور المتضخّم للأيديولوجيا فيه، وضعف مستوى البناء المعرفى لمقالات ذلك الفكر.
يقول عن ذلك: «المفكّرون والكتّاب العرب تجاه هذه المنظومة الفكريّة، أو تلك من التى يتّصلون بها قراءة واستعمالًا، تبدو أكثر ما تبدو فى ميْل كتاباتهم إلى التّبشير بالأفكار التى اعتنقوها، وتنزيلِها فى نصوصهم منزلةَ الحقّ الذى لا يطاله شكّ».
ومع ذلك، يرى المؤلف أن نصوص الفكر العربى لا تنقسم بصورة واضحة بين نصوص معرفية وأخرى أيديولوجية، وإنما يختلط فيها البُعدان، فيظهر البُعد الأيديولوجى من خلال سؤال النص الضمنى أو الانحياز الفكرى لمذهب ما.
كما أن هذا التضخم الأيديولوجى كان له ما يبرره بمرحلته التاريخية والسياسية، ففى النصف الأول من القرن العشرين، وبين منتصف الستينيات وبداية الثمانينيات من القرن نفسه، كشفت اللحظة الأولى عن محدودية نتائج الحقبة الليبرالية فى السياسة، وتراجع أفكار دعاة النهضة والتقدم، مقابل صعود خطاب الإسلاميين.
وفى اللحظة الثانية مع فشل الثورة، تكشفت محدودية إنجاز أهداف النهضة، فكان على الفكرة التاريخية أن تعاود الظهور بوصفها السبيل الضرورى للتقدم، فبدا تاريخ الفكر العربى انتصارًا لأفكار السلف وللمنزع التبشيرى الأيديولوجى.
يدرس «بلقزيز» خطاب عدد من المفكرين العرب فى مراحل تاريخية مختلفة، عبر أحد أعمالهم، ليبين أوجه تلبس المعرفى بالأيديولوجى الذى لا يأتى صريحًا بمعظم الأحيان. ففى حديثه عن كتاب «زعماء الإصلاح فى العصر الحديث» لأحمد أمين، يلاحظ المفكر المغربى أن خطاب المفكر المصرى أيديولوجى، فقد اختار بعض الإصلاحيين وأهمل البعض الآخر، ومع أنه لم ينحز إلى أطروحة واحدة من الأطروحات المختارة دون الأخرى، فإن هذا لا ينفى التلبس الأيديولوجى، إذ إنه رام بيان وجاهة فكر الإصلاح الإسلامى على وجه العموم.
أما ألبرت حورانى فى كتابه «الفكر العربى فى العصر الليبرالى»، فرغم ضمّه المتوازن تيارات من اتجاهات مختلفة، فإنه عمد إلى التبشير بأفكار النهضويين، وهو ما يمكن تبريره فى إطار السياق التاريخى الحاكم لمنتصف القرن العشرين.
وفى تحليله لـ«أسس التّقدّم عند مفكّرى الإسلام فى العالم العربى الحديث»، للمفكر الأردنى فهمى جدعان، يعتبر «بلقزيز» أن الكتاب هو أشمل تأريخ للفكر الإسلامى الحديث والمعاصر فى الوطن العربى، ومع ذلك فبُعده الأيديولوجى يظهر فى اقتصاره على المنتمين إلى التيار الإسلامى، وفى نقده «الحاد البعيد عن الموضوعية» لتيار الحداثة بالفكر العربى.
ويشدد «بلقزيز» بشكل عام على أن النظرة التبسيطية إلى الظواهر تخفى عالمها المكتظ بالتناقضات، وأن مشكلة الوعى العربى تبقى كامنة فى النظر إلى الظواهر بوصفها كليات مغلقة، ثم بناء تصورات حولها لا تلبث أن تصبح نمطية، وهذا النمط من الوعى هو ما يحتاج إلى المراجعة والمساءلة.