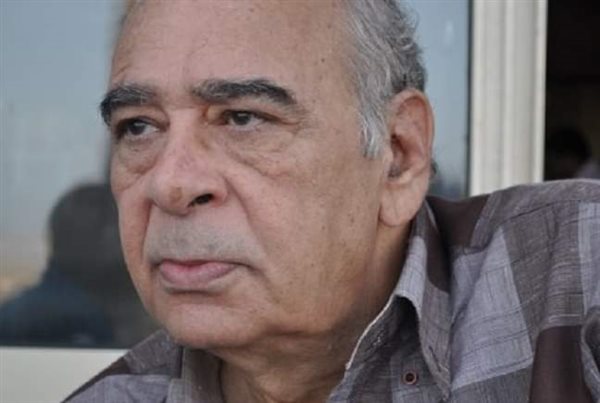حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
خلال ثلاث سنوات ما بين ١٩٥٨ و١٩٦١ غيّرنا السكن ثلاث مرات، فى المرة الرابعة كان التعب قد نال منّا، فأقمنا فى شارع نوبار ولم نغادره، كانت شقتنا فى الطابق الثانى، وتصادف أن الشاعر صلاح جاهين كان يسكن فى الطابق الرابع، وفى الخامس سكن الشاعر صلاح عبدالصبور.
ومع أننى كنت صغير السن، إلا أننى كنت أداوم على قراءة ملحق الأهرام، وأول ما حفظت من شعر كان لصلاح جاهين، بل إنه الذى جعلنى أحب الشعر، ولم أكن أعرف أننا جيران حتى صادفته ذات يوم يهبط على سلم العمارة ليخرج، فوقفت أمامه مدهوشًا، ولما وجدنى بهذه الحالة، توقف بدوره ناظرًا إلىّ، سألته مبهورًا: «أنت صلاح جاهين؟».. تأملنى لحظة لكن بعمق مستفسر، وأجاب على مهل: «أيوه.. أنا صلاح جاهين»، رفعت رقبتى لأعلى وقلت بتعجب: «ياه».. فضحك بقوة وقال لى: «هو إيه اللى ياه؟».. قلت له: «إنت شاعر بجد»، لم يقهقه لكن عينيه ابتسمتا وقال: «والله؟ ده رأيك فعلًا؟»، ثم بدا كأنه يحاول أن يتذكر شيئًا وسألنى: «إنت من أى شقة؟ إنت ابن مين؟ إسمك إيه؟».. قلت له: أحمد عبدالرحمن الخميسى، قال: «آه قول لى كده بقى، أنا كمان بقول اللماضة دى مش صدفة.. طيب يا سيدى عن إذنك بقى»، وهبط السلالم وأنا أشيّعه ببصرى وأتذكر بإعجاب رباعياته التى حفظتها مبكرًا جدًا.
حينذاك كان ابنه الشاعر بهاء جاهين صغيرًا مثلنا يمشى فى ممرات العمارة رافعًا رأسه عاقدًا ذراعيه خلف ظهره، لا يتحدث إلينا، نقول له ونحن عيال: تعالى العب معنا، فينظر إلينا بكبرياء لطيفة ويهز رأسه بالنفى، ويواصل سيره متأملًا شيئًا ما، فنذهب نحن لنلعب فى الشارع بالكرة، وكانت المنطقة هادئة تمامًا.. وفيما بعد اعتبرت أنا لسبب ما أننى وصلاح جاهين أصدقاء، فكنت إذا لم ألحق بشراء أهرام يوم الجمعة أصعد إلى شقته وأدق الجرس، فيخرج لى: عاوز إيه؟. أجيبه بعشم وبدرجة من الخجل: «عاوز الأهرام يا عم صلاح»، يهتف نصف ضاحك، نصف جاد: «يا ابنى عيب.. أبوك صحفى.. اشتروا الجرايد»، ثم يختفى ويرجع حاملًا الجريدة.
فيما بعد ترك جاهين العمارة ومن بعده صلاح عبدالصبور، وظللنا نحن وحدنا، وأخذت المنطقة التى كانت هادئة تصبح محلًا لضجيج لا يحتمل، وضوضاء باعة لا تنقطع. سافرت مدة إلى الخارج لأنهى دراستى، وحين رجعت وجدت أن المكان لم يعد محتملًا، فقد أصبح مصنعًا للمشروع القومى للضوضاء، وعثرت لنفسى على شقة فى مدينة نصر فى منطقة هادئة، لكن أمى عرضت علىّ أن تذهب هى إلى مدينة نصر وأبقى أنا فى شقتنا فى وسط البلد على أساس أن عملى يستلزم وجودى فى المركز.
رفضت ذلك، لأننى كنت أعلم أنها لن تستطيع أن تفارق شارع نوبار، وهى التى يعرفها كل بائع فيه، وكل كناس، وكل شحاذ، هى أشهر شخصية فى الشارع، تخرج كل صباح إلى الشرفة وتقف تنظم حركة مرور عربات الخضروات والفاكهة وتصيح: «روح هناك إنت يا على.. وإنت يا بتاع الجوافة.. تعالى هنا»، ولم أشأ أن أحرمها من ذلك المركز القيادى ولا من المنطقة التى ألفتها، فذهبت وسكنت فى مدينة نصر بحثًا عن الهدوء.
وكما هى العادة كان الحى فى البداية هادئًا، ثم أخذت تغزوه الضوضاء شيئًا فشيئًا، ومن بين كل أنواع الضجيج أجدنى أميّز فى نحو الواحدة ظهر كل يوم قنبلة صوتية تنفجر: «بطيخ حمار وحلاوة»!، مواطن صعيدى مع تروسيكل، بنى آدم، لكن إذا رأيت كتفيه خُيل إليك أن الصعيد كله محتشد فيهما، وإذا سمعت زعيقه زلزل الرعب قلبك، صحيح أنه ينادى على البطيخ «حمار وحلاوة»، لكن نبرته تشى بمعنى آخر: «اشترِ البطيخ وإلا أصبحت وقعتك سودة»، وحاول، واجتهد، إذا واتتك الشجاعة أن تقول للصعيدى: «هذا لا حمار ولا حلاوة».
فى معظم الأحيان ألوّح للبائع من النافذة بمنديل أبيض مستسلمًا، وأشترى تحت تهديد صوته البطيخة القرعة، ثم أجلس وأستعيد ذكريات شارع نوبار وفترة الهدوء وصعوبة الضوضاء، فأهبط إلى الصيدلية وأطلب «سدادة أذن»، وأتمنى وأنا أمام الصيدلى لو أن لديهم بالمرة سدادة عقل، تمنع عنى بالمرة ضوضاء بعض الأنشطة الثقافية.